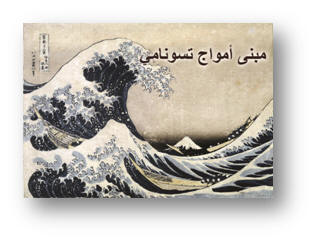|
|
 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
تشرين الثاني 2008 العدد (19) |
مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا |
November 2008 No (19) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
الإعلام تجارة لتحقيق الربح وليس رسالة وذلك ضمن ثقافة "لا علاقة لي.." غياب الكوادر الصحفية العارفة بعلوم البيئة ومخاطر تلوثها انعدام الثقافة والوعي البيئي لدى الشارع دفع بالإعلام إلى تهميش القضايا البيئية الإعلانات التجارية للخدمات المضرة بالبيئة سبب رئيسي سمر شاهين / غزة خاص بآفاق البيئة والتنمية
يذكر مختصون في البيئة أن الإعلام البيئي يفترض أن يقف دوما على مكامن الأسباب الحقيقية وراء القضايا التي من شانها تهديد البيئة وإيصالها إلى مرحلة الخطر الحقيقي، وهذه الأمور في مجملها تشكل مادة خصبة للإعلانات التي تعود بالدخل على الوسائل الإعلامية المختلفة وهذا ما لاحظته "آفاق للبيئة والتنمية " حينما عقدت ورشة عمل حول الأخطار البيئية – الصحية الناجمة عن أبراج الهواتف الخلوية حيث لم تحظ بتغطية إعلامية بقدر خطورة هذه المحطات، والسبب في ذلك كما يجمع المسئولون أن إعلانات شركات الهاتف الخلوي تعد مصدرا أساسيا لدخل العديد من وسائل الإعلام، حتى وإن كان على حساب البيئة الفلسطينية وصحة الإنسان الفلسطيني والذي يعد أغلى ما نمللك وفق تصريحات الكل!! وأجمع العديد من الإعلاميين على أن الجهل الكبير في قضايا البيئة المختلفة يعد سببا رئيسيا لإهمال وسائل الإعلام التعاطي مع هذه القضايا، إضافة الى غياب الكادر الإعلامي المتخصص، مؤكدين أن الدراسات العلمية والأكاديمية تكاد تخلومن وجود دراسة تتناول غياب الإعلام البيئي في وسائل الإعلام الفلسطينية. ولفتوا إلى أن المطلعين على الخطط الإعلامية لمختلف الوسائل سيجدون أن القائمة تخلومن هذا التخصص وأن وجد فإنه سيكون في أدنى درجة من سلم الاهتمام، وبالتالي سيبقى طي النسيان، محملين المسئولين السياسيين مسؤولية ذلك ومطالبين باقرار قانون بيئي اعلامي يحتم على كل وسيلة اعلامية ان تخصص مساحة لطرح القضايا البيئية، وأن تضم هذه المساحة زاوية معنونة بارشادات بيئية من أجل لفت انتباه المواطنين. واجمعوا على ضرورة أن تاخذ الجامعات بعين الاعتبار إدخال الإعلام المتخصص والتركيز على الإعلام البيئي لأن دمار البيئة يعني دمار الانسان، معربيين عن استياءهم من تكرار التخصصات بين جامعات الوطن دون البحث عن زوايا ابداعية وجديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإعلام البيئي. كل هذا يحدث، بالرغم من أن الإعلام البيئي يعتبر من الجوانب الهامة، بقدر جوانب أخرى مثل السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها، لأنه خطوة اساسية في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة ورغم ذلك فهومن المجالات الإعلامية المتخصصة التي لا تحظى باهتمام واسع من قبل المسئولين فحسب وإنما أيضا من الوسائل الإعلامية المختلفة، ويتضح ذلك من خلال غياب المساحات التي تعطيها الصحف بشكل خاص لتغطية ومتابعة مختلف الأمور والأحداث البيئية أوالتحقيقات الصحفية التي تتناول البيئة ومشاكلها وقضاياها، وبخاصة لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياة الإنسان وطريقة حياته، ولكن السؤال يكمن في مدى معرفة المواطن لحقيقة أن البيئة هي وسط نعيش فيه وبالتالي يجب حمايتها ومراعاتها كمحيط نتعايش معه. "آفاق البيئة والتنمية" استطلعت آراء عدد من الإعلاميين الشباب الذين مازالوا في بداية الطريق وطرحت عليهم سؤال "ما هوالسبب وراء إهمال الجانب البيئي في الإعلام الفلسطيني بصورة خاصة وعلى المستوى الخارجي بصورة عامة".
التقسيمة الصحفية سبب الإعلامية آلاء أبوعيشة مراسلة الجزيرة توك تقول :" يهمل الإعلام الفلسطيني القضايا البيئية لعدة أسباب أولها تزاحم الأحداث السياسية على الساحة الفلسطينية الأمر الذي يدعوبالعاملين في حقل الإعلام إلى ترقيتها إلى أخبار "بمستوى أول"" على حساب ليس فقط الإعلام البيئي بل على حساب حقول أخرى ومجالات أخرى من مجالات الإعلام أما السبب الثاني فهو نقص الكوادر البيئية "سواء على مستوى التعليم الأكاديمي، أوعلى مستوى البحث العلمي البيئي، أوحتى على مستوى الكوادر الصحفية العارفة بعلوم البيئة ومخاطر تلوثها على سبيل المثال" مما شجع على تهميش هذا المجال. وتتابع حديثها وتقول: "السبب الثالث هوعدم وجود وسائل إعلامية متخصصة، أوصفحات أوبرامج إعلامية متخصصة (وإن وجدت، فهي لا تغطي إلا جزءا يسيراً جدا من حجم الوسيلة) وهذا أيضاً سبب. وسبب آخر هو أن ترتيب أوليات التقسيمة الصحفية ترجع إلى ذات التقسيمة التي حددها الشارع لنفسه.. بمعنى أن الشارع يرى أن أهم ما يعنيه في بلاد كفلسطين هو الوضع السياسي وبالتالي نجد وسائل الإعلام تضع السياسة في قمة أولويات الخبر. وما بعده الشارع يرى أن الوضع الاقتصادي في المستوى الثاني وهكذا جعله الإعلام ثم الاجتماعي.... وتشير أبوعيشة إلى أنه في الوقت الذي انعدمت فيه الثقافة البيئية والوعي البيئي لدى الشارع الفلسطيني نفسه فإن وسائل الإعلام أيضاً أسقطت هذا الأمر على نفسها فهمشت ما يهمشه الشارع وجعلت القضايا البيئية "ورغم أنها في حقيقة الأمر قضايا مهمة على مستوى الحياة" جعلتها في آخر سلم الأولويات.
إعلام حزبي مسيس "لا شك أن الإعلام البيئي مهم جداً في حياتنا فهو يحذر الجمهور من مخاطر بيئية كبيرة قد تهدد حياته وبيئته التي يعيش بها والتحذير من هذه المخاطر أحد أبرز وظائف الصحافة" بهذه الكلمات بدأ الصحافي مصطفى حبوش الإجابة على سؤال آفاق للبيئة والتنمية. ويضيف حبوش الذي يؤكد أنه يناقش بين فترة وأخرى موضوعا بيئيا عبر صحيفة فلسطين التي يعمل بها :" إن الإعلام الفلسطيني غير مهتم بطرح قضايا البيئة لأسباب عدة أهمها أنه بمجمله إعلام حزبي ويخضع لسياسة الحزب الذي يتبعه وبالتأكيد الأحزاب السياسية لا تهتم بقضايا البيئة وتضعها على الهامش، وتركز على نشر أفكارها ومناهجها، وقلما نجد بعض وسائل الإعلام تهتم بهذه الجوانب، ولكن بشكل محدود وغير موسع. ويتضح أنه من بين الأسباب قلة الإمكانيات وندرة الخبراء ويقول : " فللأسف الوطن العربي بشكل عام، والضفة والقطاع بشكل خاص، تخلو من خبراء البيئة ومعظم الموجودين هم مجرد متخصصين لا يمتلكون الخبرة الكافية لطرح قضايا بيئية جادة، وإضافة إلى قلة الإمكانيات البشرية فأيضا هناك نقص حاد في القدرات المادية فوسائل الإعلام الفلسطينية نطاق دخلها محدود ولا تكاد تغطي نفقات العاملين. ويضيف: "كما وأن وسائل الإعلام المحلية لا تمتلك الصحفيين ذوي الكفاءة لطرح القضايا البيئية فمعظم الصحفيين نطاق فكرهم محصور في آلية تغطية الأحداث والأخبار السياسية، والكثير منهم لا يحمل حتى شهادة جامعية معتمداً على بعض الدورات التي تلقاها في مجال الصحافة والإعلام. أرى أن تغطية القضايا البيئية ومتابعتها يحتاج إلى صحفي ذي كفاءة ويمتلك الكثير من الثقافة والمعلومات حول هذه القضايا، وإلا ستكون تغطيته سطحية ولن يستطيع التعمق في القضية التي يحاول أن يطرحها. ويشير حبوش إلى أن الأحداث المحلية التي تسيطر على الساحة والتي تحوز على الاهتمام الأكبر بمجملها أحداث سياسية تتولد نتيجة لوجود الاحتلال الإسرائيلي والجمهور أول ما يثير اهتمامه هومعرفة هذه الأحداث لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياته. هناك الكثير من القضايا البيئية التي من المهم طرحها وتناولها، وأهمها قضية تلوث مياه البحر بالمياه العادمة والحفر المفرط للآبار وحرق النفايات ومحطات تقوية بث الهاتف الخلوي وعوادم (السيارات القديمة) – السيارات القديمة والتالفة تصدر عوادم خطيرة جداً وغير مفلترة كالسيارات الحديثة مما يتسبب بسحابة كبيرة من الدخان الأسود التي يمكن أن تتسبب بالسرطان. ربما هذه بعض الأسباب التي يمكن أن تمنع وسائل الإعلام من الاهتمام بالقضايا البيئية ولكن أرى أن من المهم تدريب كفاءات صحفية ومحاولة العثور على خبراء وترك السياسة الحزبية المقيتة التي تتبعها كافة وسائل الإعلام المحلية، وأتمنى أن تطل علينا ولووسيلة إعلامية واحدة تتحدث عن مثل هذه القضايا البيئية التي من الممكن أن تدمر مجتمعات بأسرها بل ودول.
الاحتلال سبب الصحافي خالد معالى من سلفيت بنابلس يقول لآفاق للبيئة والتنمية ردا على السؤال: "يمكن إرجاع سبب إهمال القضايا البيئية في مجتمعنا الفلسطيني ومن قبل الإعلاميين إلى خصوصية وجود الاحتلال وما يصاحب ذلك من أهمية التركيز على القضايا اللحظية المتعلقة بالاحتلال من بناء المستوطنات ومصادرة الاراضي والحواجز والاقتحامات والتوغلات، فلا يعقل مثلا أن يكون الانسان يعاني من العطش ويفكر في أي قضية أخرى سوى إرواء عطشه، فكل مرحلة لها ما يناسبها من أدوات. ويضيف: "ويمكن القول أيضا إن إهمال القضايا البيئية يرجع إلى ضعف الوعي البيئي لدى الشعب الفلسطيني لاسباب عديدة، وهو ما ينعكس على الإعلاميين لأن الإعلاميين يسبحون في بحر الجماهير وبالتالي عدم تناول قضايا البيئة بما تستحقه. وهناك ايضا سبب يتعلق بالوضع الاقتصادي العام والمتردي فكلما ضعف الاقتصاد في أي دولة قل الاهتمام بالقضايا البيبئة من خلال البحث عن الحاجات الاساسية، وهو ما يشكل عامل ضغط على الإعلاميين لتناول قضايا أقل أهمية من البيئة بحكم الفقر مثلا" هكذا يقول. في المحصلة من الصعب حصر موضوع المشكلة في سبب واحد لأن مجموعة عوامل هي المسببة لإهمال قضايا البيئة من قبل الإعلاميين، وهذا أيضا يدلل على قصور الإعلامين في هذا الجانب لأنه يفترض أن يكون الاعلامي دائما هوالمبادر وليس المتلقي للحدث وناقل له فقط. ثقافة وأنا مالي الصحفي محمد الدلويقول:" فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى عدم وعي نسبة كبيرة من فئات المجتمع، بثقافة الحفاظ على البيئة بكافة أنواعها ( الأرض، البحر، الجو)، وعلى سبيل المثال لوتفقدنا موقعاً على شاطئ البحر ارتاده مجموعة من الإعلاميين لوجدنا أن أحداً منهم لم يفكر في تنظيف الشاطئ خلفه – وهذا لا يعني التعميم. أضف إلى ذلك أن المواطن الذي هوإعلامي أوصحفي بات يتقن ثقافة ( وأنا مالي.. ليست مسئوليتي وحدي)، وبات الإعلام تجارة لتحقيق الربح وليس رسالة. القضايا السياسية الفلسطينية تأخذ حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام المحلية على حساب قضايا أخرى ليس البيئة فحسب بل النسيج الاجتماعي المتفكك كنتاج لعوامل وخلافات سياسية. ويشير إلى غياب التوجيه والرقابة، إذ لا توجد مراكز متخصصة تعمل على توعية وتنبه المواطن بخطورة عوادم السيارات على طبقة الأوزون، وعمليات الاحتباس الحراري، أوخطر مياه الصرف الصحي على الأحياء البحرية. ويضيف الدلو الصحفي والمحاضر في الكلية الجامعية: "التوعية بأهمية البيئة غائبة عن المناهج الدراسية، وإن وجدت فهي يقدم في إطار نظري تقليدي يغيب عنه البرنامج التدريبي، بدليل لوأننا راقبنا مجموعة من الطلبة طُلب منهم تنظيف فناء المدرسة لوجدنا أن نسبة 50% منهم يهربون، وإن حدثت استجابة فتكون قائمة على الترهيب وليس الترغيب أوالتحفيز.
الإعلانات السبب الأخطر ويشير الصحافي حسني نديم مهنا المحرر في صحيفة فلسطين إلى أن وسائل الإعلام المحلية تحاول تجنب قضايا البيئية وذلك لعدد من الأسباب أهمها قلة الوعي لدى الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام وعدم إدراكهم لأهمية القضايا البيئة وبخاصة في فلسطين. ويوضح أنها تركز –أي وسائل الاعلام- على البحث عن الموضوعات التي تحظى بالإقبال الجماهيري؛ وذلك سعياً وراء الشهرة والانتشار الأوسع،الاتجاه نحوالقضايا التي تجلب الدعم المادي للمؤسسة الإعلامية سواء أكانت سياسية أورياضية أوترفيهية...الخ. بعض الشركات تحاول تغيير دفة المؤسسة الإعلامية نحوالاتجاه المعاكس لقضايا البيئة من خلال إعلاناتها في هذه المؤسسة. ويلفت إلى التركيز على القضايا السياسية والميدانية في ظل الأوضاع المتوترة والمشحونة، والبعد عن قضايا البيئية مع العلم أن القضايا البيئية مرتبطة بشكل كبير مع القضايا السياسية والميدانية. ويختتم حديثه فيقول:": وعليه يجب على وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية أن تفرد مساحة جيدة للبرامج المتخصصة في قضايا البيئة وأخبارها، وعلى العلماء والباحثين في مجال البيئة الذين يمثلون جزءا من الإهمال أويساعدونه ويعززونه من خلال صمتهم تجاهه يجب عليهم أن ينفتحوا على هذه الوسائل الإعلامية، لضمان انتشار المعلومات والمفاهيم البيئية وتثقيف المواطنين بقضايا البيئة لتحقيق التنمية المستدامة. وعلى المنظمات الدولية والعالمية المختصة أن تدفع بالقضايا البيئية، بوسائل الإعلام إلى الوجهة الصحيحة في مجالات البيئة والعمل على تنظيم مشاريع لتطوير الإعلام البيئي في فلسطين ولتعزيز إستراتيجيته، كما أنه يجب على المنظمات الأهلية العاملة في مجال البيئة أن تلعب دوراً بارزاً في نشر الثقافة والتوعية البيئية لدى مختلف فئات المجتمع. وفيما يتعلق بالجانب الحكومي أيضا يؤكد أنه يجب على الحكومة ومؤسساتها أن تساعد وسائل الإعلام المحلية المختلفة من خلال التعاون المشترك بينهما لتمكين الإعلاميين من الوصول إلى مصادر المعلومات البيئية وإشراكهم في رسم السياسات البيئية والخطط والبرامج الإعلامية المعدة بشأنها والهادفة إلى تطوير الإعلام البيئي، ومساعدتهم في إيجاد طرق لمعالجة مشكلات البيئة عبر هذه الوسائل لإيصال الفائدة إلى اكبر قدر من المواطنين الفلسطينيين الذين تتعرض بيئتهم إلى أوسع عملية تدمير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تتبع سياسية الأرض المحروقة دائما في عملياتها ضد الشعب الفلسطيني للنيل منه ومن بيئته؛ وذلك في محاولة منها لمنع الفلسطينيين من التمتع بأي حق من حقوقهم التي كفلتها المواثيق والمعاهدات العالمية بان يحظى هذا الإنسان ببيئة صحية نظيفة. على جميع الإعلاميين بذل الجهد اللازم لمواكبة قضايا البيئة والعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية الهادفة للنيل من البيئة الفلسطينية.
غياب الكادر الإعلامي المتخصص بدورها تقول الاعلامية زينب عودة: "الإعلام المحلي يهمل قضايا عدة هامة ومن ضمنها القضايا البيئية بل وأهمها . وقد يرجع السبب فى ذلك لأطراف عدة منها بالأساس عدم وجود كوادر اعلامية محلية فلسطينية ذات وعي وثقافة بالقضايا البيئية وكيفية معالجتها إعلاميا وعبر وسائل الاعلام المختلفة سواء المقروءة أوالمرئية أو المسموعة، وعدم اهتمام وسائل الاعلام ذاتها بهذه القضايا ومنحها المساحة المناسبة والعرض المشوق بل نجد أن وسائل الإعلام يهمها العائد المادي والإعلانات وغيرها من المساحات التى لاتتناول هذه القضايا". إضافة لما سبق لا يوجد تشجيع من قبل المؤسسات بطرح هذه القضايا بشكل متواصل، وإن وجدت مؤسسات تكون قلة قليلة غير متناسبة؛ وهذا ينطبق على البلديات والمحافظات والوزارات ذات العلاقة والمختصة منها الصحة والزراعة والمياه، وحتى على صعيد المدارس لايوجد تثقيف جاد بهذه القضايا كما أن الجامعات ليس لها دور فاعل .. بمعنى أن القضايا البيئية ليست من الأولويات . وبالتالي أطراف عدة تشترك بعضها مع بعض تساهم بقصد أو دون قصد فى تعميق الجهل بالقضايا البيئية؛ وهنا لاننسى دور الاحتلال الاسرائيلى الذى دمر البيئة الفلسطينية، وكان ومازال يواصل عملية ممنهجة لتدميره من خلال المستوطنات والاستيلاء على المياه وإغراق الاراضى الفلسطينية بالنفايات وكل مايضر البيئة . ويؤكد أحد خبراء البيئة على أن مفاهيم الإعلام البيئي تتخذ عددا من المراحل المهمة التي تخلق ثقافة بيئية لدى المجتمعات وبخاصة عند النشء، وتمر عبر مراحل مختلفة منها إعلام الناس بكل ما يختص بالبيئة والمحافظة عليها في مرحلة ما قبل المدرسة في الروضة، من أجل زرع مفهوم البيئة وضرورة حمايتها والمحافظة عليها منذ الصغر حيث يكون الطفل على استعداد جيد للشعور بكل ما هو جميل ورائع في عالم الطبيعة والنبات والحيوان؛ بحيث ينمي هذا الشعور والمحبة للبيئة منذ نعومة الأظفار فيؤثر على تصرفات الطفل وردود فعله تجاه مختلف مظاهر الحياة بكل ما فيها من جمال وروعة، ولا بد من اهتمام طلاب المدارس في جميع المراحل الدراسية بتجميع الصور والمعلومات والنشرات بالإضافة إلى القيام ببعض الأنشطة المفيدة، وإجراء بعض الأبحاث الصغيرة المتعلقة بالبيئة وحمايتها، ثم تنمي هذه الأنشطة والمعلومات مع تدرجهم الدراسي. ويضيف: "إذا ما نجح القائمون على وسائل الإعلام البيئي في زرع هذه المفاهيم عند النشء من خلال الأنشطة المدرسية لكونها بداية للتجربة والاطلاع عند الصغار، سيصبح الأمر أسهل في تقبل هؤلاء المتلقين الصغار عند نضجهم لفكرة وجود تسليط للضوء على البيئة ونواحيها المختلفة ونموهم وهم يملكون وعياً وإحساساً بأهمية الالتفات للقضايا البيئية". ويختتم حديثه فيقول: "لذلك، إذا ما نجحنا في غرس مفاهيم الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها ونقلنا صورا إعلامية عن الأنشطة البيئية، من خلال وسائل الإعلام وبخاصة الإذاعة والتلفزيون، بتوجيه برامج منوعة عن البيئة، والسعي لحمايتها، فاننا سننعم ببيئة صحية وسليمة وآمنة في الحاضر والمستقبل من خلال توعية الصغار لضمان قيام مجتمع واعِ بيئياً". |
||||||||||||||||||||||||
|
موجات جفاف متكررة وطويلة وشديدة ستضرب فلسطين خلال السنوات المئة القادمة ج. ك. خاص بآفاق البيئة والتنمية
تكرر تعبير "الجفاف" مرارا في السنوات الخمس الأخيرة التي تميزت بشح الأمطار في فلسطين. وكما يبدو، سيلاحقنا هذا التعبير لسنوات طويلة في المستقبل. إذ، بالرغم من تنبؤ الأرصاد المناخية لفصل شتاء قد يتجاوز بأمطاره المعدل السنوي، إلا أن حالة الأمطار، على مدى السنوات الطويلة القادمة، لن تتحسن كثيرا. ففي السنوات المئة القادمة، يتوقع خبراء المناخ بأن تضرب فلسطين المزيد من موجات الجفاف التي ستكون أكثر تواصلا وأقل كمية متساقطات من تلك التي عرفناها في السنوات الأخيرة. وحسب نموذج بحثي فحص مؤخرا ظاهرة الجفاف في فلسطين، خلال السنوات المئة الأخيرة، تمكن الباحثون من توقع احتمالات الجفاف خلال السنوات المئة القادمة، وتحديدا في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2100. وتبين بأن هذه الفترة سيتخللها زيادة في فترات الجفاف، وتحديدا من 12.5 فترة جفاف خلال السنوات المئة الأخيرة إلى أكثر من 20 فترة جفاف خلال السنوات المئة القادمة، علما بأن معظم فترات الجفاف ستكون في السنوات الأخيرة للقرن الواحد والعشرين. كما تبين بأن طول فترات الجفاف المتوقعة سيزداد تدريجيا من 3 – 4 سنوات في المتوسط في العقود الأولى للقرن الحالي- تماما كما كان الحال في المئة سنة الأخيرة – ليصل إلى 7 – 8 سنوات في العقود الأخيرة من نفس القرن. وقد استندت التقديرات البحثية السابقة إلى أن هبوطا في كمية المتساقطات بمقدار 25%، يتوقع حصوله بين بداية القرن ونهايته. أي أن كمية المتساقطات في نهاية هذا القرن ستبلغ ربع الكمية في بدايته. يضاف إلى ذلك، أن ليس فقط تكرار فترات الجفاف وطولها سيزدادان، بل إن شدة الجفاف ستزداد أيضا. وإذا كان نقص المياه في فترات الجفاف الحالية يتمثل في نحو ألف مليمتر، فإن هذا النقص قد يصل مستقبلا إلى نحو ثلاثة آلاف مليمتر. وتكتسب المعطيات البحثية السابقة أهميتها باعتبارها بوصلة الوضع المائي المستقبلي في فلسطين، وباعتبارها تساعد أيضا في تخطيط السياسات المائية المستقبلية. ومع ذلك، فإن مثل هذا التخطيط المائي الاستراتيجي غير ممكن في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرا للهيمنة الإسرائيلية المطلقة على مصادر المياه والأحواض الجوفية، وتحكمها بالتالي في الضخ والحصص والتوزيع. |
||||||||||||||||||||||||
|
متى ستضرب أمواج تسونامي الساحل الفلسطيني؟! ج. ك. خاص بآفاق البيئة والتنمية
ذكرتنا أمواج تسونامي التي ضربت شواطئ جزيرة "سَمْوا"
الأميركية أوائل أكتوبر الماضي، بالخطر الحقيقي الذي تشكله
تلك الأمواج العاتية التي قد يصل ارتفاعها عشرات الأمتار.
ومنذ كارثة تسونامي التي ضربت جنوب شرق أسيا قبل نحو خمس
سنوات، أدركت العديد من الدول مدى الطاقة التدميرية
الكامنة في أمواج تسونامي. لذا، تستثمر حاليا مبالغ ضخمة
في تطوير أنظمة إنذار متطورة تساهم في إنقاذ حياة مئات
آلاف الناس. والسؤال المطروح هو: ما احتمال أن تضرب أمواج تسونامي الشواطئ الفلسطينية؟ يقول بعض خبراء الزلازل إن السؤال المطروح لا يكمن فيما إذا كارثة تسونامي ستحدث في فلسطين أم لا، بل السؤال هو: متى ستحدث الكارثة؟. ففي أعقاب التسونامي المدمر في المحيط الهندي عام 2004 والذي قتل أكثر من 225 ألف نسمة، بينت الأبحاث أن البحر المتوسط، يعد، من الزاوية الإحصائية، ثاني منطقة في العالم من ناحية عدد المرات (الموثقة) التي ضربتها أمواج تسونامي حتى الآن، وهي تساوي ربع عدد حالات تسونامي المعروفة. وقد تبين أيضا بأنه، في المتوسط، يحدث كل 100 سنة في منطقتنا (البحر المتوسط) تسونامي ضعيف، وفي كل 200 سنة يحدث تسونامي قوي؛ بينما يحدث كل 1000 سنة تسونامي مدمر. إلا أن معظم حالات التسونامي تحدث بسبب الزلازل القوية الناتجة عن إزاحات في موقع الكسر بأرضية البحر، أو نتيجة انزلاقات كتل أرضية مائلة في اليابسة، إثر هزة أرضية. إذن، احتمال حدوث تسونامي مرتبط باحتمال حدوث زلزال قوي يزيد على 6 درجات في سلم ريختر. وبما أن هناك احتمالا كبيرا بحدوث زلزال بهذه القوة في منطقتنا خلال السنوات الخمسين القادمة، فإن احتمال أن يتسبب مثل هذا الزلزال في أمواج تسونامي وارد جدا. ويوجد توثيق للعديد من حالات أموج تسونامي في منطقة البحر المتوسط. ومن هذ الحالات، على سبيل المثال، أمواج تسونامي التي ضربت شواطئ الجزائر عام 2003، حيث تسبب زلزال بقوة 6.8 في موجة تسونامي أحدثت أضرارا في 100 قارب بجزر الكناري. وقد حدثت أيضا موجة أعنف في منطقة صقليا (إيطاليا) عام 1908، حيث قتل آنذاك 70 ألف شخص وجرح 200 ألف. وفي فلسطين، لا يوجد توثيق لوفيات بسبب تسونامي، إلا أننا نعرف بالتأكيد أن أمواج تسونامي ضربت شواطئ فلسطين عام 1546، وتحديدا منطقة الساحل الممتدة من غزة حتى يافا، فضلا عن ضربة أخرى بسبب زلزالين عام 1759 في منطقة عكا.
ما هي الأضرار المتوقعة من تسونامي قوي في الشواطئ الفلسطينية؟ حتى الآن، لا توجد تقديرات علمية حول الأضرار المتوقعة في قطاع غزة. إلا أن هناك توقعات إسرائيلية تتعلق بأمواج تسونامي قوية قد تضرب منطقة الساحل في وسط فلسطين وحيفا. ففي حال انزلاق كتل أرضية، إثر هزة أرضية، من المتوقع أن تضرب المنطقة المذكورة أمواج تسونامي بارتفاع 6 أمتار فوق سطح البحر. أما في حال حدوث زلزال في منطقة جزيرة كريت، على سبيل المثال، فقد يصل ارتفاع الأمواج إلى عشرة أمتار. وعندئذ، سيتضرر ويغرق كل الساحل الفلسطيني، بما فيه ساحل غزة. ويتوقع خبراء إسرائيليون بأن تتسبب موجة تسونامي في منطقة تل أبيب - حيفا في إغراق ما يعرف بشارع "يركون" (تل أبيب) وجميع المسابح والمرافق السياحية والترفيهية الأرضية التي على شواطئ تل أبيب وهرتسيليا. أما في خليج حيفا، فسيغرق الشاطئ وجزء من الميناء، بما في ذلك شارع الملوك (المسمى إسرائيليا "هعتسماؤوت"). وستغرق أيضا برك التبريد في محطة الطاقة الكهربائية في الخضيرة، مما سيتسبب في انقطاع كامل للكهرباء لفترة طويلة.
ما مدى الاستعدادات لمواجهة أمواج تسونامي في فلسطين؟ بسبب الحصار الخانق المفروض على أهلنا في قطاع غزة وحالة الشلل التي تعيشها المؤسسات والجهات العلمية والمهنية المعنية، فإن استعداد القطاع لمثل هذه الكارثة هو عمليا صفر. كما أن الاستعدادات الإسرائيلية في الساحل الفلسطيني الممتد من يافا حتى عكا ليست جيدة. ويوجد حاليا في عمق البحر المتوسط نظام إنذار يفحص المعطيات الخاصة بالموجات الزلزالية التي يتم قياسها، والتي تفيد في معرفة مدى النشاط الشاذ للطبقات الأرضية، أي فيما إذا كان هناك زلزال في منطقة البحر المتوسط يفوق 6 درجات. وبناء على ذلك، يتحدد مدى لزوم إصدار إنذار حقيقي حول تسونامي. وحاليا، يتم إنشاء نظام آخر في البحر المتوسط لفحص ارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع إنجاز هذا النظام بعد نحو عامين. وفي كل الأحوال، يجدر بسكان الساحل، عند إحساسهم بزلزال قوي، أن يبتعدوا فورا عن الشواطئ وأن يحاولوا الوصول إلى مواقع ترتفع عن سطح البحر بما لا يقل عن 5 – 10 أمتار.
ما هي أمواج تسونامي وما سماتها؟ "تسونامي"، كلمة يابانية الأصل مكونة من كلمتين: "تسو" ومعناها ميناء، و"نامي" ومعناها موجة، أي أنها تعني "موجة الميناء". وتتكون هذه الأمواج، في أغلب الأحيان، نتيجة للاهتزازات المرافقة لحدوث الزلزال في قعر البحار، وقد تصل سرعتها إلى 800 كم / ساعة. وليست الزلازل هي السبب الوحيد في حدوث أمواج تسونامي، وإن كان أكثر من 80% من "التسونامي" يحدث في أعقاب الزلازل. فقد تتولد أمواج "تسونامي" بسبب الانفجارات البركانية أو الانهيارات الصخرية في قاع البحار أو في المناطق الساحلية، أو إثر ارتطام أجسام فضائية كالنيازك (من طبقات الجو العليا) بسطح البحر. وكثيرا ما يتم الخلط بين أمواج "تسونامي" وأمواج المَد أو الأمواج البحرية العادية. أمواج "تسونامي" ليست موجات مَد، ولا أمواجاً بحرية عادية. أمواج المَد (عكس الجَزْر)، كما تعلمنا في الصفوف الدنيا، تحدث يوميا بسبب تفاعلات الجاذبية بين القمر والشمس والأرض. أما الموجات البحرية فتتولد نتيجة لاحتكاك التيارات الهوائية مع سطح البحر، وهي، غالبا، أمواج سطحية محدودة الارتفاع، ولا تتجاوز المسافة بين الموجة والأخرى 30 مترا. بينما ما يميز أمواج "تسونامي" التي يكثر حدوثها في المحيطين الهادي والهندي، أنها طويلة جدا، وعميقة، فقد يصل طولها إلى140 كيلومترا، وعمقها قد يتجاوز عشرة كيلومترات. أما متوسط سرعتها فيتراوح بين 750 – 800 كيلومتر في الساعة، وهي تتناقص كلما انخفض عمقها.
وعندما تقترب أمواج "تسونامي" من الشاطئ تنخفض سرعتها، لكن
ارتفاعها يزداد بسبب ارتطامها بأرضية الشاطئ، محدثة رد فعل
يؤدي إلى تضخيم فجائي للموجة.
وقد يتراوح ارتفاعها (عندما تصل إلى الشاطئ) بين 30 إلى
40 مترا فوق سطح البحر. وقد يتواصل اندفاع أمواج "تسونامي" من بؤرة الزلزال في جميع الاتجاهات (بمعدل سرعة 800 كم / ساعة). وقد تتواصل هذه الأمواج أكثر من ساعة، بل قد تمتد بضعة أيام، بسبب الزلازل الارتدادية التي قد تحدث بعد الزلزال الرئيسي. إذن، طاقة أمواج "تسونامي" تُسْتَمَد من حركة الأرض (الانزلاقات في القشرة الأرضية)، وليس من الرياح. كما أن الفترة الزمنية بين إحدى أمواج “تسونامي” والموجة التي تليها قد تصل إلى أكثر من ساعة كاملة. وتمتلك تلك الأمواج قوة تدميرية هائلة، إذ قد تصب نحو 100 ألف طن من الماء على كل متر مربع من الشاطئ؛ وبالتالي قد تتسبب في خسائر أفظع من خسائر الزلزال نفسه. فهي تجرف رمال الشواطئ، وتقتلع الأشجار، بل قد تدمر مدنا وقرى بأكملها. ومن فرط قوتها، تحمل أمواج “تسونامي” الصخور الضخمة التي تُثَبَّت في البحر لصد الأمواج (كواسر الأمواج)، والتي قد يصل وزن الصخرة الواحدة منها عشرين طنا، حيث تقصفها أمواج “تسونامي” مسافة عشرين مترا. ومساحة تأثير أمواج "تسونامي" كبيرة جدا. ففي حال كون قوة الزلزال كبيرة جدا، أي 9 درجات حسب مقياس ريختر (كما حدث في زلزال جنوب آسيا في كانون الأول 2004)، فقد تصل الأمواج إلى مناطق تبعد آلاف الكيلومترات عن المركز السطحي للزلزال وفي المباحثات التمهيدية لإبرام اتفاق جديد يهدف إلى تجنب الآثار المدمرة لتغير المناخ، وافقت معظم الدول على ضرورة العمل لمنع ارتفاع حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين، قياسا بمستوى درجة الحرارة التي كانت سائدة قبل العصر الصناعي. ولتحقيق هذا الهدف يجب، حتى عام 2020، تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بين 25 – 40% دون المستوى الذي كان سائدا عام 1990. وحاليا، وافقت الدول الغنية على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 15 – 23%. وتتمثل أهم آليات إنجاز هدف التخفيض الجدي للانبعاثات الغازية، في التوافق العالمي على التحول إلى اقتصاد متدن في استهلاك للكربون؛ مما يعني زيادة كبيرة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي المقابل، التقليل من استهلاك الفحم والنفط. وهذا بالضبط ما يخيف حكام السعودية. |
||||||||||||||||||||||||
|
20 مليون حاوية نفايات غير قانونية تغادر الموانئ الأوروبية سنويا نحو الدول النامية الجانب المظلم في أوروبا "الخضراء": دفن نفايات أوروبية سامة وخطرة في أراضي الدول الفقيرة الولايات المتحدة التي لم توقع على اتفاقية بازل تصدر كميات ضخمة من نفاياتها إلى "العالم الثالث" ج. ك. خاص بآفاق البيئة والتنمية
يتضمن "الوعي الأخضر" والقوانين البيئية في أوروبا جانبا
مظلما. إذ كلما واجهت المصانع الأوروبية المزيد من
الصعوبات لحل مشكلة النفايات التي تنتجها، ازدهرت أكثر
الصناعة الجانبية المتمثلة في تهريب النفايات إلى الخارج.
وإجمالا، النفايات التي يعد دفنها أو تدويرها في أوروبا
وأميركا الشمالية مكلفا جدا، يتم التخلص منها بشكل غير
قانوني، وأحيانا بشكل "قانوني" في الدول الفقيرة حيث
الرقابة والقيود البيئية ضعيفة، مما يسهل رشوة أشخاص
معينين كي يغضوا النظر عن الحاويات التي تصل الموانئ،
والتي تفوح منها روائح مشكوك بها. وقد اكتشف مؤخرا وجه آخر لهذه الظاهرة في إيطاليا. إذ تعمل المافيا لصالح مصانع مختلفة تنتج نفايات سامة وخطرة يصعب معالجتها على الأرض الأوروبية بسبب التكلفة المرتفعة والتعقيدات الكامنة في عملية المعالجة؛ فتلجأ المافيا إلى إخفائها خارج إيطاليا. وقبل أكثر من شهر أعلن عن كشف سفينة تم إغراقها أمام الشواطئ الإيطالية الجنوبية، وقد حوت على متنها حاويات من المواد المشعة. وقال المتعاون الذي كشف عن موقع السفينة بأنه هو وأصدقاءه اعتادوا التخلص بهذه الطريقة من النفايات الخطرة، بل وأحيانا أبحروا فيها حتى الشواطئ الصومالية للتخلص منها هناك. وفي المقابل، وصلت إلى ميناء برازيلي شحنة بريطانية ذكرت الإرسالية الخاصة بها أنها تحوي تبرعات للمحتاجين. إلا أن تلك الشحنة كانت، في الحقيقة، عبارة عن 1400 طن من أقمطة الأطفال القذرة، ونفايات بيولوجية خطرة وثياب وسخة. وأدى اكتشاف هذه الشحنة إلى إحراج السلطات البريطانية إحراجا شديدا، فضلا عن إشكال دبلوماسي مع البرازيل. وتحاول الشركات، أحيانا، تهريب النفايات بذريعة أنها مكونة من مخلفات إلكترونية للتدوير. وعلى سبيل المثال، ضبطت مؤخرا في ميناء روتردام بهولندا شحنة من هذا القبيل، وقد تضمنت أطنانا من المكونات الإلكترونية، وأسلاكا كهربائية وأجهزة تالفة، فضلا عن الكثير من رزم البلاستيك والكرتون. وكانت الصين هي هدف الشحنة المعدنية، إلا أن سلطات حماية البيئة الهولندية صادرتها، باعتبار أنها خالفت القوانين المشددة المتعلقة بتصدير النفايات من دول الاتحاد الأوروبي.
يتنفسون غازات سامة وتعتبر بعض النفايات المصدرة "قانونية"، وبخاصة عند الحديث عن تصدير نفايات لمصانع تدوير قانونية في الدول النامية. فمن المشروع إعادة تصدير سلع تم إنتاجها في أسيا إلى دول المنشأ، بهدف تدويرها أو إعادة استعمال مخلفاتها هناك. يضاف إلى ذلك، أن في الاقتصاديات النامية طلبا شبه دائم على المواد الخام مثل البلاستيك والورق والزجاج والمعدن. وتعد هذه طريقة فعالة لاستغلال آلاف الحاويات التي تصل إلى موانئ أوروبا وأميركا الشمالية وهي محملة بالبضائع الرخيصة من آسيا. فبدلا من إعادتها فارغة يتم تعبئتها بمواد خام للتدوير، فضلا عن خردة معدنية أو نفايات عضوية. وحسب وكالة البيئة الأوروبية، ازداد، في الفترة بين 1995 – 2007، حجم النفايات الورقية والبلاستيكية والمعدنية التي تم تصديرها من أوروبا، بمقدار عشرة أضعاف، علما بأن 20 مليون حاوية غادرت الموانئ الأوروبية سنويا. وبينما كان الجزء اليسير من هذه الصادرات "قانونيا"، فإن معظمها غير قانونية. وأحيانا، يتم الإعلان عن النفايات المصدرة باعتبارها مخصصة لإعادة الاستعمال، إلا أن مآلها النهائي الحقيقي هو التفكيك. ويتم الإعلان عن نفايات أخرى بأنها للتدوير، لكن مصيرها يكون المحارق أو المكبات في الدول الفقيرة. وأشار تقرير أخير أصدرته وكالة البيئة الأوروبية، إلى بعض نماذج التخلص من النفايات الأوروبية. فالمواد الخام (البلاستيكية والمعدنية، على سبيل المثال) يعاد تدويرها في آسيا (وبخاصة في الصين والهند). أما النفايات الإلكترونية فتصل إلى الدول الإفريقية. وإجمالا، يمكن دائما في مثل هذه الدول الفقيرة إيجاد من هم على استعداد لتسهيل عملية دفن النفايات الأوروبية في بلدهم، طمعا في الحصول على بعض المال. وفي كل الأحوال، تعد مسألة دفن النفايات الغربية في الدول الفقيرة قنبلة بيئية قابلة للانفجار في أية لحظة، وبخاصة النفايات الإلكترونية التي تحوي معادن سامة ورقائق بلاستيكية؛ فعملية تفكيك المعدات الإلكترونية إلى مكوناتها الأصلية بهدف إعادة بيعها لإعادة الاستعمال، تتضمن استنشاق وملامسة مواد خطرة. والأولاد هم الذين غالبا ما يعملون في مثل هذه الأشغال، بسبب رخص عمالة الأولاد. وكثيرا ما يتم حرق النفايات الأوروبية الغربية الخطرة في محارق عشوائية في البلدان الفقيرة، وبتكلفة هامشية، علما بأن التخلص منها في الأراضي الأوروبية مكلف جدا. أما التكلفة الحقيقية فيدفعها العاملون في تلك المحارق أو السكان القاطنون في محيطها والذين يتنفسون الدخان والغازات السامة. وأحيانا يتم إلقاء النفايات الغربية في المساحات المفتوحة المنتشرة بكثرة في الدول النامية، دون معرفة أحد. وتترك النفايات في تلك المساحات حتى تتعفن تحت الشمس والمطر. وتتمثل خطورة هذه الظاهرة، حينما تلقى النفايات قرب الأنهار وفي مداخل المدن، وبالتالي تؤدي إلى تلوث الأرض ومصادر مياه السكان الفقراء القاطنين في محيط تلك النفايات. هذا ما حدث، على سبيل المثال عام 2006 حينما ألقيت نفايات خطرة في ساحل العاج، مما تسبب في تلويث مصادر المياه. وبمساعدة منظمة بيئية، رفع السكان المحليون دعوى ضد الشركة الهولندية التي أرغمت على تعويضهم بمبلغ 30 مليون باوند إنجليزي. ليس فقط أوروبا، بل أيضا الولايات المتحدة الأميركية تصدر كميات كبيرة من نفاياتها إلى العالم. وحسب تقرير لمنظمات بيئية في هونكونع، تصل يوميا إلى ميناء المدينة نحو مئة حاوية نفايات من أميركا الشمالية. وبينما يوجد في أوروبا أنظمة تفرض قيودا على تصدير النفايات، وهي تحديدا الأنظمة المتضمنة في اتفاقية بازل، فإن الولايات المتحدة لم توقع على تلك الاتفاقية، وبالتالي لا تسري القيود عليها! وتعتبر الولايات المتحدة أن القيود الوحيدة المفروضة عليها هي تلك المتعلقة بتصدير النفايات الخطرة كما تم تعريفها في القانون الأميركي، مثل المعادن الثقيلة والسموم، ولا يشمل التعريف النفايات الإلكترونية التي تحوي تلك المواد بداخلها. "أصبحت حركة النفايات ضخمة"، كما يقول كريستيان فيشر مستشار وكالة البيئة الأوروبية لشئون النفايات. أما في هولندا التي تتصدر عملية متابعة ورقابة حركة النفايات، فيقولون إن 16% على الأقل من إجمالي صادرات النفايات الهولندية غير قانوني. إلا أن الوضع في العديد من الموانئ الأوروبية غير واضح؛ إذ إن كميات هائلة من النفايات تمر منها دون رقابة، في طريقها إلى أحد الموانئ في العالم الثالث.
تاريخ طويل من الجرائم ضد البيئة والإنسانية ومن بين أبرز الجرائم ضد البيئة والإنسانية، أن بعض الدول الصناعية “المتقدمة” التي سُنَّت فيها قوانين مشددة لحماية البيئة من أخطار النفايات، وبالتالي منع دفنها في أراضيها، تتخلص من نفاياتها الصناعية والنووية السامة والخطرة، من خلال تصديرها ودفنها في أراضي ومياه الدول النامية التي يحكمها فاسدون جُلّ ما يهمهم مصالحهم الشخصية المريضة وتلقي الرشوات المالية، دون أن تؤنبهم ضمائرهم على تسببهم في تلويث بيئة بلدانهم ونشر المرض والموت فيها. وأحيانا، تلقى النفايات السامة في الدول النامية خلسة، دون علم الأخيرة، وبخاصة خلال فترات عدم الاستقرار والحروب الأهلية. وتعمد بعض الدول “المتقدمة” إلى إلقاء نفاياتها في مياه الدول النامية، بالاتفاق مع مجموعات مسلحة محلية، كما حدث في أثناء الحرب الأهلية في لبنان. ففي ظل الفوضى التي سادت البلاد، وتعدد السلطات فيها، خضعت بعض الموانئ فيها لسيطرة المليشيات التي استغلتها لاستيراد النفايات الخطرة، مقابل حصولها على مبالغ مالية تنفقها على تسليح نفسها.
إلقاء النفايات النووية في السواحل الصومالية ومن أبشع الجرائم البيئية، نذكر الاستغلال الأوروبي للمياه الإقليمية الصومالية، وذلك عبر الصيد البحري غير الشرعي للأسماك المشهورة في المنطقة (كالدلفين والقرش والتونا والسيف وغيرها)، وإلقاء النفايات النووية والكيميائية الخطرة أمام السواحل الصومالية. وقد حدث ذلك إثر سقوط نظام الرئيس الصومالي السابق محمد زياد بري عام 1991، وهزيمة القوات الأميركية التي حاولت الهيمنة على الصومال وثرواته (عام 1992)، فشهدت البلاد فوضى أمنية وحروبا عشائرية بين جنرالات الحرب، مما أدى إلى تجزئة الصومال إلى مناطق مختلفة يحكم كل منها جنرال معين. لقد عملت سفن بعض الشركات الأوروبية، وبخاصة شركتي “بروجريسو” الإيطالية و”أتشير” السويسرية، على إفراغ شحنات النفايات الخطرة بشكل عشوائي في مياه الصومال الإقليمية، وعلى مسافة كيلومترات قليلة من سواحله. وادعت تلك الشركات أنها وقعت اتفاقيات مع الحكومة الصومالية سمحت لها بإلقاء النفايات النووية المميتة في السواحل الصومالية، وقد تبين كذب هذا الادعاء، نظرا لعدم وجود حكومة في الصومال أساسا في تلك الفترة! وما حدث في الواقع، هو أن تلك الشركات استغلت الفوضى الطويلة التي انتشرت في الصومال، فأبرمت مع جنرالات الحرب المحليين، اتفاقات إجرامية للتخلص من النفايات السامة في الصومال، وقد حصل الجنرالات على عشرات الملايين من الدولارات التي استخدمت أساسا في تمويل الحرب الأهلية. لقد ألقوا اليورانيوم المشع والكادميوم والرصاص والزئبق وغيرها من المواد الكيميائية السامة والمميتة على الشواطئ الصومالية، دون مراعاة لصحة الصوماليين وللتأثيرات المدمرة بيئيا على المنطقة. ومنذ العام 1992 وحتى يومنا هذا، ونتيجة لهذه الكارثة البيئية التي خيم عليها تعتيم إعلامي غربي رهيب، توفي وأصيب آلاف الصوماليين بصمت، بسبب الأمراض التي أصابتهم بتأثير المخلفات الأوروبية السامة. ومن أبرز هذه الأمراض: السرطان، والتشوهات الخلقية، وإصابة النخاع الشوكي بأذى شديد، والاضطرابات العصبية الشديدة، والصدمات القلبية القاتلة.
|
||||||||||||||||||||||||
|
متى يصبح الهم البيئي في أولويات الإعلاميين الفلسطينيين؟ دلالات وجود أمثلة ناجحة في تعميم الخبرات وتوسيعها في الوسائل الأخ
تحسين يقين خاص بآفاق البيئة والتنمية
سعدت بتنظيم مركز العمل التنموي / معا ندوة حول الإعلام البيئي، لكنني لم أستطع حضورها بسبب سفري خارج البلاد، وسأكون سعيدا حين أطلع على ما تم توثيقه من حديث فيها، والحقيقة أن هذا الموضوع يهمني وعددا من الزملاء منذ فترة، وقد كان للباحث والإعلامي الأستاذ جورج كرزم دور أساسي في توجيهنا إلى هذا التخصص الإعلامي، عبر تشجيعنا وتثقيفنا المستمر، حتى باتت البيئة جزءا من اهتماماتنا اليومية. تعكس البرامج البيئية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية واقع الإعلام البيئي في فلسطين، فباستثناءات قليلة منثورة هنا وهناك لها صفة الموسمية المرتبطة بمشاريع محددة زمنياً، أولها صفة التمويل الخارجي، فإن هذا النوع الإعلامي الهام والحيوي محدود بالرغم من الأهمية الاستراتيجية للوعي البيئي المرتبط بالأرض الفلسطينية محل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. بادئ ذي بدء ينبغي وضع موضوع الإعلام البيئي ضمن سياق الإعلام الفلسطيني المتخصص، والذي لم يظهر بشكل ملموس إلا بعد قيام السلطة الفلسطينية، حيث انعتق الإعلام الفلسطيني بشكل عام من الزجاجة التي اعتقله فيها الاحتلال بقيوده على النشر من خلال الرقيب الإسرائيلي، ففي الضفة الغربية وقطاع غزة لم يكن قبل عام 1995 إعلام متخصص سوى الإعلام الرياضي والقليل من الإعلام الثقافي والإعلام السياسي الخاضع للرقيب. وقد انسجم مع تلك الظروف حال البلاد تحت الاحتلال التي جعلت الإعلام المتخصص ليس على رأس أولويات وسائل الإعلام، أضف لذلك أصلاً قلة الكوادر الإعلامية المدربة والمتخصصة في مجالات الحياة المختلفة. لذلك جاء الإعلام البيئي الفلسطيني ضمن تطور الإعلام المتخصص، وإن يكن الإعلام البيئي ما زال اقل تطوراً وانتشاراً من غيره من الأنواع، مثل إعلام المرأة، والتربية، والطفل والأسرة والديمقراطية وحقوق الإنسان والثقافة.
البيئة في الصحف اليومية والمجلات في العادة لا تخصص الدوريات الفلسطينية صفحات للبيئة، وليس هذا فقط، بل إن تناول الأمور البيئية قليل جداً، ولا يعتمد بالضرورة على الكادر الصحفي من مراسلين أو محررين، الذين قد يتعرضون لمشكلة بيئية بعد أن يتم تناولها مجتمعياً، أو يكون لها علاقة بسياسة إسرائيل التدميرية للبيئة مثل المكبات الملوثة كيماوياً وغير ذلك، مثلاً اكتشاف دفن المخلفات النووية جنوب الخليل لم يغط إعلامياً كما ينبغي، ولم يتم تناوله في مقالات الكتاب، واقتصرت التغطية على تقرير عن ندوة تناولت الموضوع، وكان من الضرورة أن يغطى في عدة تحقيقات. لذلك فإن إثارة الأمور البيئية تأتي من خارج الصحف، وربما يعود ذلك إلى نقص خبرة الصحافيين العلمية بالإضافة إلى أن التحقيقات الصحفية هي ضعيفة في الصحف الفلسطينية بشكل عام لكونها تحتاج الوقت والمعرفة والتدريب والتحليل والوصف والمقابلة وغير ذلك من المهارات.
صفحة تنموية وبيئية من هنا جاءت مبادرة مركز العمل التنموي معاً في أوائل عام 1995 حتى عام 1999 في الاتفاق مع صحيفة "القدس" ثم فيما بعد صحيفة "الأيام" على أن يقوم المركز بتزويد الصحيفتين بمواد تغطي صفحة أسبوعية بعنوان التنمية والبيئة، أو شؤون تنموية وبيئية. لكن تحرير هذه الصفحة لم يكن ليتم بالشكل المقبول، فصحيفة "القدس" الصادرة في القدس المحتلة، تخضع للرقيب الإسرائيلي، كما أن موضوع البيئة ليس أولوية على جدول الجريدة. كان محتوى الصفحة له علاقة بالتوجه التنموي والزراعي البيئي والعضوي، ودعت إلى الزراعات العضوية الخالية من السموم الكيماوية، "لكن وضع الصحيفة إعلانا حول سماد كيماوي أو مبيد دون معرفتنا، يعرض أهداف الصفحة للخطر، لأن ذلك يتعارض مع توجهنا" كما قال محرر الصفحة جورج كرزم، كما أن القطاع الخاص ضغط على الجريدة وتم إيقافها. ومن التحقيقات المهمة التي عارضها الوكلاء الفلسطينيون للمنتجات الإسرائيلية، لأنها تتعارض مع مصالحهم المادية، تحقيق حول إغراق السوق الفلسطينية بالسلع الإسرائيلية الزراعية والغذائية. بعد حوالي 5 سنوات توقفت الصفحة التي كان يحررها مركز العمل التنموي / معاً ويقدمها مجاناً، تاركةً فراغاً، حيث كانت نافذة إعلامية لبث هموم البيئة، وتوعية المواطنين في هذا المجال.
البيئة في المجلات: ملحق البيئة والتنمية صحيح أنه لا يمكن اعتباره مجلة، سواء من ناحية الشكل (تابلويد 16 صفحة) أو من حيث المضمون (الإيقاع، عدد الكلمات، العمق) إلا أننا نستطيع أن نذكر أن النشرة /الصحيفة الشهرية "البيئة والتنمية" تمثل حالة من النضج في التناول الإعلامي وفتح المجال أمام الناشطين البيئيين والخبراء للكتابة. إلا أن صحيفة البيئة والتنمية تمول من مرفق البيئة العالمية، ويعني ذلك أن صدورها مرتبط بالتمويل الذي مهما طال سيظل محدوداً بفترة زمنية للمشروع. تجلس خريجة إعلام شابة في مكتب محرر ملحق "البيئة والتنمية"، لتعد تقريراً بيئياً، حول أثر العمران على الأراضي الزراعية، حيث تتعرف على الزوايا التي يمكن تناول الموضوع من خلالها، ذلك أن الصحافي غير المتخصص يصعب عليه إعداد موضوع متخصص وهو بحاجة لتوجيه ورعاية. بعد 6 سنوات من صدور ملحق البيئة والتنمية الذي يوزع مجاناً مع صحيفة "الأيام" الفلسطينية، بدأت اتجاهات لتطوير أدوات كتابة الملحق من خلال تقوية الجانب المهني نفسه، ثم تعميق المعرفة في قضايا البيئة الفلسطينية لديهم بشكل مركز، عن طريق ورش العمل والندوات والمحاضرات مواضيع الملحق هي في الأساس فلسطينية، مع تناول الأحداث البيئية البارزة في الخارج، ذلك أن الهم البيئي الفلسطيني، ومحدودية عدد الصفحات تجعل المحرر يركز على البيئة الفلسطينية ومشاكل التنمية. من المواضيع البارزة في الصحيفة المتخصصة آثار الاحتلال الإسرائيلي في تخريب البيئة والزراعة في فلسطين، الأساليب السليمة في التعامل مع البيئة، تغطية أخبار البيئة، مقالات حول التربية والمعرفة البيئية، المنتجات الإسرائيلية وأثرها على كساد سوق الفلاحين الفلسطينيين، الأسمدة والمبيدات الكيماوية، نقد اتجاهات رسمية في التعاطي مع الأرض من زوايا إنتاجية وفق سياسة الاستهلاك، تجارب ريادية بيئية، المرأة والبيئة، أي أن مواضيع "البيئة والتنمية" لها علاقة بتخريب إسرائيلي للبيئة الفلسطينية وعدم قيام السلطة الفلسطينية بواجباتها نحو البيئة والزراعة، ومجالات أخرى لها علاقة بالزراعة التطبيقية والوعي البيئي. ومنذ مطلع عام 2008، وحتى هذه اللحظة، يعكف مركز معا على إصدار مجلة بيئية إلكترونية شهرية (آفاق البيئة والتنمية: maan-ctr.org/magazine) تحولت عمليا إلى موقع إلكتروني مرجعي وثري بالمعالجات النظرية والتطبيقية، ويتميز الموقع بطرح قضايا بيئية حساسة وساخنة يغيبها الإعلام المحلي. نشرات المؤسسات غير الحكومية محدودة، وصفحاتها قليلة، وهي مرتبطة بعلاقتها بالجانب السياسي والاشتباك مع الاحتلال. في مكتبة بيت لحم يستطيع الزائر التعرف على المنظور الذي يتم النظر من خلاله إلى مواضيع البيئة، حيث يهتم مركز "أريج" بالأرض والبيئة تحت الاحتلال وآثار المستوطنات وجدار الفصل العنصري على الأرض، ويتميز المركز بقدرات تكنولوجية، واستخدام الحاسوب في عرض المعلومات والسيناريوهات المختلفة، كما أن لديهم صورا جوية التقطت خصيصاً من أجل أبحاثهم. تنشر "أريج" التوعية البيئية عن طريق البوسترات والخرائط والمشاركة في الندوات وفي التلفزيونات المحلية، والمحاضرات، كما تبعث انتاجاتها إلى المسؤولين في المجالات السياسية. وهي تصدر تقريرا عن الانتهاكات والنشاطات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وآثارها على المصادر الطبيعية. ويصدر المركز نشرات غير دورية، كما يغطي ويوثق نشاطاته في مجال بحوث تطوير المصادر والحفاظ على الأصناف البلدية والنباتات البرية.
التلفزيون والإذاعة أضعف الوسائل، مع أنها الأكثر أهمية تناولاً لمواضيع قضايا البيئة؛ إذ إن الإذاعة والتلفزيون يختصران الاهتمام فقط على مجرد الخبر. فيما عدا ذلك، كانت وزارة الزراعة قد تعاونت مع الإذاعة في إعداد برنامج زراعي يهتم بقضايا المزارعين ويوجههم، وكان يبث صباحاً. أما المحاولة الأولى لوجود إعلام بيئي مسموع في الإذاعة فكانت عام 2006، وتمت بالتعاون بين الإذاعة ومركز العمل التنموي (معاً)، من خلال الخبير الإعلامي والتنموي جورج كرزم. وكان البرنامج حلقة أسبوعياً، تعاد مرة أخرى بواقع 7 دقائق، تناولت المشاكل البيئية الفلسطينية، واستضافت خبراء ومهندسين زراعيين.
الإعلام البيئي في الضفة الغربية وأثره في نشر الوعي بين السكان
رائد موقدي خاص بآفاق البيئة والتنمية
في ظل احتفال الوطن العربي في 14 شهر تشرين الأول الماضي بيوم البيئة العربي، يعتبر الشأن البيئي هاما ورئيسيا في الضفة الغربية نظرا للوضع البيئي السيئ الذي نعاني منه والآخذ في التدهور، والناتج عن عدة أسباب أهمها الوضع السياسي والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية وإقامة الجدار الفاصل الذي يصادر في طريقه أخصب الأراضي، وبخاصة المزروعة بأشجار الزيتون والفواكه واللوزيات وغيرها، واستنزاف مياهها وسياسة العقاب الجماعي ومنع المواطنين من زراعة أراضيهم والمحافظة عليها وتهريب ونقل النفايات الصلبة من إسرائيل ودفنها في الأراضي الفلسطينية، وتعطيل إقامة مكبات صحية. كل ذلك أدى إلى تعرض البيئة الفلسطينية إلى تهديدات خطيرة أدت إلى مشكلات بيئية متعددة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الوضع البيئي الحالي المتردي قد نتج عن تدمير متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي شمل تدمير البنية التحتية لقطاع البيئة ومن ذلك طمر النفايات الخطرة والسامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مكبات النفايات، وتدمير شبكات وأحواض الصرف الصحي وشبكات وآبار المياه، إضافة إلى الاستنزاف المستمر للمصادر الطبيعية ومنع الفلسطينيين من استغلال حقوقهم من هذه المصادر، وذلك في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية لإقامة المستعمرات عليها والطرق الالتفافية ونقل المصانع الملوثة وغير المقبولة بيئياً إلى داخل المستعمرات مما ترك آثاراً سلبية على الصحة العامة والتنوع الحيوي في الضفة. فالمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 تواجه تحديات وصعوبات حقيقية وكبيرة في سبيل تحقيق برامجها في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي تواجه البيئة الفلسطينية الناتجة من تطور شبكات الاتصالات والخلويات في الأراضي الفلسطينية وما لها من تأثير على صحة الإنسان ، علاوة على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر محمية طبيعية للكثير من المنتجات والسلع الضارة على البيئة وعلى صحة الإنسان والتي تنتشر بشكل واسع دون رقابة بشكل الصحيح عليها ، ومن هنا جاءت الأهمية القصوى إلى ضرورة تفعيل دور الأعلام البيئي لما له من دور بارز في توعية عامة الناس وخلق رأي عام فلسطيني مدرك لخطورة التحديات التي تواجه البيئة الفلسطينية، وضرورة وضع الحلول السريعة لها والضغط على أصحاب القرار والنفوذ للسير في طريق الحد من الاخطار التي تواجه البيئة الفلسطينية.
حضور الإعلام البيئي وتأثيره على الساحة الفلسطينية: للإعلام البيئي دور فاعل ومؤثر بوسائله المختلفة على كافة الشرائح العمرية والمهنية والاجتماعية في مسألة التفاعل الايجابي مع قضايا البيئة ومشاكلها من جهة، والحث على إصدار قرارات بيئية لإعادة التوازن للنظام البيئي الذي أصابه الخلل من جهة أخرى. تشير دراسة مسحية صادرة عن مركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي في بيت لحم لسنة 2008 أعدها الدكتور نبيل كوكالي المحاضر في جامعة الخليل أن(78.1%) ممن شملهم الاستطلاع قلقون على حالة البيئة في الأراضي الفلسطينية، وأن (74.9%)ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن تلوث البيئة هو المشكلة الأكثر خطورة على الساحة الفلسطينية، و. (84.7%) يعتبرون أن سوء إدارة شؤون البيئة السبب الرئيس في تدهور البيئة ، ومن هنا جاء دور الأعلام الفلسطيني في نشر الوعي عند الشرائح المختلفة من أبناء الوطن حول الواقع البيئي في الأراضي المحتلة، وإزالة اللبس والمغالطات في أحيان كثيرة عن أمور يجب الوقوف عندها وتوضيحها وكشفها لعامة الناس. إلا أن الإعلام البيئي الفلسطيني رغم ذلك يعتبر مغيبا في كثير من الأحيان عن أمور كثيرة تخص القضايا البيئية الفلسطينية وإن تطرق إليها فبشكل سريع ويمر عليها مر الكرام دون متابعة لها ورصدها بشكل صحيح، وتوصف وكأنها خبر عام، وفي كثير من الأحيان يطغى الخبر السياسي على الخبر البيئي وكأن الأخير شي ثانوي ينتهي مفعوله خلال ساعات محدودة؛ ومن هنا نستطيع القول إنه لم نصل من خلال الإعلام البيئي إلى الهدف المنشود وهو جعل السلوك البيئي الإيجابي والصحيح سلوكا يوميا للمواطن، وعند المراجعة والوقوف عند الأسباب الكامنة وراء ذلك نجد أن الخلل الأكبر هو في الجهات الإعلامية المختلفة والسبب هنا عدم وجود إستراتيجية وطنية مستدامة للتوعية والإعلام البيئي في المؤسسات الإعلامية؛ وبالتالي عدم وجود خطط وبرامج عمل واضحة لتطبيق هذه الإستراتيجية من قبل مديريات ودوائر المؤسسات الإعلامية، والتي من شأنها تنشيط الإعلام البيئي، فعلى سبيل المثال هناك مديرية للإعلام التنموي في وزارة الإعلام، ودائرة للبرامج التنموية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومعروف أن الإعلام البيئي جزء لا يتجزأ من الإعلام التنموي، ومع ذلك لم يحظ الإعلام البيئي بالخطط وبرامج العمل اللازمة، كذلك عدم تفعيل جانب الإعلام البيئي المجتمعي الواسع الانتشار بصورته الصحيحة، أي تفعيل دور وسائل الإعلام المحلية وخطب الجمعة وفي المدارس، وتفعيل الإعلام البيئي الذي يكون على صورة إعلانات لافته للانتباه، وفي نفس الوقت معبرة عن المرافق العامة، وعلى جانبي الطرق الرئيسة على اللوحات الإعلانية، والتي من شانها جلب انتباه المشاهد ومن ثم تعلق الصورة بذهنه .. كذلك يقع على الإعلاميين أنفسهم اللوم في التقصير في كثير من النواحي الإعلامية الخاصة بالبيئة، حيث يوجد عزوف بشكل واضح عن الإقبال على الأعلام البيئي عند كثير من الإعلاميين، حيث يمكن تبرير ذلك:
1-طبيعة المشكلة البيئية لا تشكل سبقاً صحفياً إلا إذا
تعلقت بكارثة بيئية أو بأضرار فادحة ناتجة عن التلوث. 4- عدم تشجيع القائمين على المؤسسات الإعلامية للصحفيين ودفعهم للخوض في مجال البيئة، وعدم تخصيص صفحات كافية في الجرائد أو برامج في الإذاعة والتلفزيون تهتم بشؤون البيئة والتوعية البيئية، والافتقار إلى الأرشيف التخصصي والمكتبة التلفزيونية، أو أحيانا نشرة بسيطة تصدر في أوقات محددة، وانخفاض الأجور التي يتم منحها عن الموضوعات والريبورتاجات التي تحتاج إلى جهد ومال كبيرين، واقتصار دور الإعلام على إبراز الإيجابيات، والابتعاد عن كشف السلبيات التي تلحق بالبيئة، وبخاصة قضايا الاتصالات وأبراج هواتف النقالة المنتشرة في كل مكان وعلى أسطح الكثير من المنازل. في هذا الصدد يعقب الإعلامي سامر خويره من قناة القدس الفضائية: "يعتبر الإعلام البيئي إعلاما ضعيفا في فلسطين، ويعود ذلك إلى قلة البرامج التلفزيونية البيئية في حين يكون تركيز الإعلام بشكل أساسي على الأخبار السياسية. مع عدم إعطاء جانب كاف لقضايا البيئة، ويتم الاستعاضة عنها بنشرات بسيطة تصدر كملحق هامشي؛ حيث إن غالبية عامة الناس لا تتابع هذه المواضيع بأي شكل من الأشكال. كذلك عدم وجود خطة إعلامية متكاملة واستخدام مصطلحات بيئية غير مفهومة عند كثير من عامة الناس ساهم في عدم فهم كثير من القضايا البيئية. لذلك، فإن أفضل طريقة لنشر الوعي البيئي عند كثير من الناس، وبخاصة عامة الشعب، هو عبر الإعلام المجتمعي البسيط، ألا وهو تفعيل دور المحطات المحلية والشبكات الإعلامية المحلية على مستوى الوطن لنشر القضايا البيئية، وكذلك إعداد دورات بيئية ومخيمات صيفية بيئية لطلبة المدارس، وكذلك استغلال فواتير الجوال والاتصالات التي توزع على الناس في نشر ملحق إعلامي بيئي معها، حيث هذا من شانه نشر كثير من القضايا البيئية عند أكبر شريحة من المجتمع".
اقتراحات لتطوير الإعلام البيئي: ـ التعاون بين وزارة الإعلام ومختلف وسائل الإعلام الحكومية والخاصة والتابعة للمنظمات الأهلية والشعبية والنقابات وغيرها، لوضع خطة وطنية للإعلام البيئي تنسجم مع الظروف البيئية التي نمر بها في فلسطين. ـ تنظيم حملات إعلامية بيئية للمواضيع الهامة الطارئة أو ذات الأولوية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل (إدارة النفايات وتلوث الهواء وغيرها من المشاكل البيئية الملحة مثل الصرف الصحي، شح المياه في سنوات الجفاف، وهدر الطاقة..). ـ التعاون مع الجمعيات غير الحكومية ذات الصلة بالشأن البيئي ووضع خطة تعاون مشترك لمواكبة نشاطاتها خصوصاً تلك التي تتطلب حملات توعية للعمل الشعبي التطوعي. ـ تشجيع التواصل بين الإعلاميين البيئيين والخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن البيئي، من خلال شبكة وطنية، ولوائح تضم أسمائهم وعناوينهم والحصول على آرائهم بصدد المشاكل البيئية المطروحة.
الولايات المتحدة تحول بعض الأغذية المعدلة وراثيا إلى علف للحيوانات داخل أميركا أو تقدمه كمساعدات للدول الفقيرة! شركات الهندسة الوراثية الأميركية تخفي غالبا حقيقة أغذيتها المعدلة وراثياً أكثر من 50% من الأغذية الأميركية المصنعة تحوي مكونات معدلة وراثياً
سعد داغر
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف ببعض الدول والشركات المنتجة للمحاصيل المعدلة وراثياً، إضافة إلى دور الجماعات البيئية في مناهضة التعديل الوراثي.
الدول المنتجة للمحاصيل المعدلة وراثياً يتزايد استخدام المنتجات الغذائية المعدلة وراثياً في مستوى العالم، ويزداد تنوع تلك المنتجات؛ فهناك الذرة وفول الصويا، والبطاطا والخضار المتنوعة، والأرز والقمح ومحاصيل أخرى كثيرة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للمحاصيل المعدلة وراثياً، تليها كندا، فاليابان والاتحاد الأوروبي. ويزيد عدد المحاصيل التي تنتجها الولايات المتحدة على خمسين محصولاً، وهناك مساحة تزيد على 360 مليون دونم من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة تزرع بالمحاصيل المعدلة وراثياً، ولاسيما فول الصويا، القطن، الذرة، البطاطا.
ويبين الجدول (1) أسماء بعض الدول المنتجة للمحاصيل المعدلة وراثياً والعدد التقريبي لهذه المحاصيل.
جدول (1) بعض الدول المنتجة للمحاصيل المعدلة وراثياً
المصدر: (أمين شمس الدين، تطبيقات هندسة الجينات والأغذية المعدلة وراثياً)
وهناك الكثير من الشركات العالمية التي تتعامل مع منتجات الهندسة الوراثية وتُدخلها في الأغذية التي تصنعها، وهي في معظم الأحيان لا تشير إلى أن أغذيتها من منتجات معدلة وراثياً. وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 50% من الأغذية المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من أغذية معدلة وراثياً أو أُضيفت إليها أجزاء نباتات معدلة وراثياً، وبخاصة الأغذية التي تدخل فيها منتجات الذرة والصويا. ومن الأمثلة على الشركات التي تتعامل مع منتجات الهندسة الوراثية ما هو وارد في الجدول (2):
جدول (2) شركات الهندسة الغذائية
المصدر: (أمين شمس الدين، تطبيقات هندسة الجينات والأغذية المعدلة وراثياً)
التعديل الوراثي في المحاصيل لمقاومة مبيدات الأعشاب يعتبر هدف زيادة فعالية مبيدات الأعشاب واحداً من الأهداف الرئيسة التي تعمل شركات التعديل الوراثي من خلاله على الترويج لنشاطاتها ولمنتجاتها. ومن اللافت للنظر أن شركات الكيماويات الزراعية هي نفسها من يعمل على إجراء التعديل الوراثي على المحاصيل، بهدف زيادة فعالية مبيدات الأعشاب التي تنتجها لزيادة مبيعاتها، بحيث يكون المحصول الذي تجري عليه عمليات التعديل مقاوماً لمبيد عشبي تنتجه نفس الشركة، وبالنتيجة تسوق المحصول والمبيد.
ولكن يصبح الأمر أكثر سوءاً إذا ما علمنا أن المورثة/الجين
الذي “زرع” في المحصول لمقاومة مبيد الأعشاب، يمكن أن
تنتقل في بعض الأحيان إلى الأعشاب عن طريق التلقيح بوساطة
الحشرات أو الرياح، فتكتسب هي الأخرى بدورها المناعة ضد
المبيد العشبي مما يعني زيادة في استخدام المبيدات العشبية
من حيث النوع والكمية المطلوبة. ويشكل هذا التطور الخطير
معضلة كبرى تتسبب في زيادة الإضرار بالبيئة، نتيجة الآثار
التي تخلفها المبيدات العشبية وصولاً إلى تدهور التربة
وتصحر الأراضي. ذكر الدكتور بريان جونسون المشارك في إعداد تقرير لوكالة "الطبيعة الانجليزية" حول المحاصيل المعدلة وراثياً، ذكر أن أحد أنواع الأعشاب الشديدة الإضرار بالمحاصيل أصبحت مقاومة لأربعة أنواع من المبيدات العشبية (نتيجة انتقال المورثات الخاصة بمقاومة الأعشاب من المحصول الذي تم تعديله وراثياً إلى ذلك العشب). وهذا ما يؤكد الخطر الكبير الذي يمكن أن يحدث إذا استمرت هذه النشاطات الخاصة بالتعديل الوراثي والتي لا يُعرف حتى الآن ضررها في المدى القريب أو البعيد. إن مثل هذه النتائج الكارثية التي يتوقع حدوثها (وبعض تلك النتائج حدث فعلاً) دفع بجماعات المحافظة على البيئة إلى تسمية البذور المهندسة وراثياً "بذور الشيطان"؛ وفي تقرير صدر عن الجمعية الملكية البريطانية ورد تحذير من أن تلك الأغذية الناتجة عن التعديل الوراثي قد تكون ذات قيمة غذائية أقل من تلك التي لم يجرِ عليها أي تعديل.
دور الجماعات البيئية في مواجهة التعديل الوراثي تعارض الجماعات البيئية التعديل الوراثي، وتحاول جاهدةً منع انتشاره، وقد نجحت هذه الجماعات في إجبار بعض الحكومات على سن قانون يقضي بوضع علامة على المنتجات المعدلة وراثياً، لكي يستطيع المستهلك تمييزها. مثل هذه القوانين سارية المفعول في الدول المتقدمة، في حين أنها لا وجود لها في الدول النامية حتى هذه اللحظة.
ونورد هنا بعض الإنجازات التي حققتها جماعات معارضة التعديل الوراثي: أولاً: لقد أجبر المستهلكون حكومة بريطانيا على إصدار قانون في 31/12/1999 يشترط توسيم أو تعليم المنتجات الآتية من محاصيل معدلة وراثياً، ولكن في أمريكا لم ينجحوا في ذلك حتى هذه اللحظة، والسبب أن «حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقف، بتوجيه واضح من الشركات العملاقة، ضد وضع العلامة أو التوسيم ـ تحت ذريعة "أن أي تعليم لهذه المنتجات يعتبر تمييزاً ضدها". ولكن، أليس من حق مئات ملايين البشر أن يعرفوا ما هي حقيقة غذائهم؟ أليس هذا تمييزاً ضد كل البشر حين يتم إخفاء معلومات عنهم تتعلق بغذائهم؟ إذا كانت هذه الشركات تعمل لصالح البشرية وللقضاء على الجوع، فلماذا لا تقول هذه الشركات للبشرية: هذا إنتاجنا، أنتجناه لكم بالتعديل الوراثي وتترك لهم حرية الاختيار - يأكلونه أو لا يأكلونه؟!
ثانياً: بنوك البذور الأهلية: في مواجهة السياسة الاحتكارية التي تنتهجها الشركات الاستعمارية، المنتجة للمحاصيل المعدلة وراثياً، والساعية إلى التحكم في البذور، ومنع المزارعين من إنتاج بذورهم المحلية بأنفسهم، وبالتالي التحكم في الغذاء العالمي؛ لا بد من تبني سياسة مناهضة لتلك الخطط اللاأخلاقية، ومنع الشركات من تحقيق أهدافها في احتكار البذور والتحكم بالغذاء. على هذا الأساس تتبنى مؤسسات غير حكومية إنشاء بنوك البذور الأهلية لتشجيع إنتاج البذور المحلية في مواجهة البذور المعدلة وراثيا، وفي مواجهة التحكم الذي تسعى الشركات لتحقيقه من خلال تلك البذور.
ثالثاً: السيادة على الغذاء: مبدأ سيادة الغذاء قائم على حق الإتاحة العادلة للموارد الطبيعية والإنتاجية للفلاحين والسكان الأصليين، ويعني حق الشعوب في اختيار غذائها الخاص وتبني سياسات التنمية الريفية وسياسات السوق وتشجيع استراتيجيات تنموية تراعي التوازن البيئي. كما يشتمل هذا المبدأ على سياسات تسويق تمنع إغراق السوق، وأخرى تعتمد على القطاع العام في تنمية الريف في بُناه التحتية والتعليم والصحة. هذا المبدأ طُرح لأول مرة من قبل منظمة برازيلية تدعى "فيا كمبنسينا" عام 1996 في قمة الغذاء العالمية التي نظمتها "الفاو" وعُقدت في روما. وفي العام 2006 وجهت المنظمة نداءً لمؤتمر "أرض، ومنطقة نعيش فيها، وكرامة" الذي عقد في مدينة "بورتو اليجري" البرازيلية جاء فيه: "سوف نستمر في مقاومة نموذج الإنتاج والتنمية بإجراءاته التي تفرضها العولمة، وتحويل وإدخال الزراعة في سلاسل الشركات العملاقة "المتعدية" الجنسيات - الإنتاج بالعقود، وتصدير المحصول الواحد، والهندسة الوراثية، والأغذية المعدلة وراثياً. نحن نعارض البذور المعدلة وراثياً التي تنزع وسائل سيطرة ورقابة المجتمعات الريفية على الإنتاج، وتضعها في يد ثلة من الشركات المتعدية الجنسيات". مما تقدم نجد أن المعارضة للمحاصيل المعدلة وراثياً تأخذ أشكالاً متعددة وتتسع، نتيجةً لزيادة الوعي بمخاطر هذه المحاصيل، ويزداد وعي المستهلك وطلبه في دول متعددة بضرورة الإشارة إلى المنتجات المعدلة وراثياً من خلال إشارة خاصة. وهذا يظهر أهمية دور المواطن في التصدي لانتشار هذا النوع من المنتجات، ليكون بعيداً هو وأبناؤه عن خطرها المحتمل، ويستطيع مساعدة الآخرين وتعريفهم ومشاركتهم في التصدي لمنتجات التعديل الوراثي ومخاطرها. وقد تأكدت بعض المخاطر حين تم إنتاج أحد أصناف الذرة المسماة ستارلينك (Star Link) التي تبين وجود بروتين بكتيري فيها، لا يهضم في الجهاز الهضمي للإنسان ويتسبب بالحساسية الشديدة له. وقد أمرت السلطات الأمريكية بتحويله كعلف للحيوانات داخل أمريكا، ولكنها في الوقت نفسه ترسله كمساعدات للدول الفقيرة! |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
التعليقات |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا. |
||||||||||||||||||||||||